في عام 508 قبل الميلاد، وبعد الإطاحة بأحد الطغاة أسس الكلسثنيون ديمقراطية في أثينا. وخلال عمرها الذي بلغ 186 عاماً، جلبت هذه الديمقراطية أهم تفتح للروح البشرية، لكن في نطاق جغرافي ضيق. ومع ذلك، إذا كان عمر الديمقراطية 2519 عاماً، فإن مصر أقدم منها بكثير. فقد جرى توحيدها للمرة الأولى قبل خمسة آلاف سنة لتكون بذلك أقدم دولة على كوكبنا الأرضي.
بالتالي، الدولة ككيان أقدم بكثير من الديمقراطية. وجاء اختراعها مصحوبا بسؤال: من الذي يتحكم فيها؟ كانت الإجابة عبر الزمن والمكان إنهم الملوك الآلهة، والملوك الرهبان، والقادة العسكريون، وما إلى ذلك. وربما كانت الحكومة فكرة في اهتمامات أبناء الشعب، لكنها في الغالب لم تكن في أيديهم.
كانت أثينا استثناءً عظيماً، على الرغم من أن مفهوم الحكومة المسؤولة أمام الشعب كان موجودا كذلك في روما القديمة وفي دول المدن الإيطالية. ومع ذلك لم يحقق الانتخاب المباشر انتشاراً جغرافياً على نطاق واسع. وحلّ انتخاب البرلمانات في إنجلترا في القرن الثالث عشر تلك المشكلة. وانتشر أنموذج البرلمان المنتخب الذي تعتبر السلطة التنفيذية مسؤولة أمامه في الوقت الراهن في معظم أرجاء العالم.
يقدم مشروع بوليتي الرابع في مركز السلام الشامل في جامعة جورج ماسون، تحليلاً للأنظمة السياسية في الفترة 1800 – 2009. ومن بين 162 بلدا غطتها الدراسة تبين أن 92 بلدا كانت محكومة بأنظمة ديمقراطية في 2009، بينما كانت 23 بلدا فقط تخضع لحكم الفرد، مقابل 89 بلدا عام 1977. ومن المؤسف أن 47 بلدا كانت بلدانا هشة تجتمع فيها عناصر الحكم الديمقراطي وحكم الفرد. ورغم ذلك، العالم ديمقراطي في أغلبه، وذلك للمرة الأولى في التاريخ.
وما تجدر ملاحظته هو الزيادة الكبيرة في عدد الدول الديمقراطية في التسعينيات، وهو الأمر الذي نشأ عن انهيار إمبراطورية الاتحاد السوفياتي السابق والتحول الذي شهدته أمريكا اللاتينية. ومع ذلك، بقي الشرق الأوسط شاذا عن ذلك. فعلى الرغم من تراجع عدد البلدان الخاضعة لحكم الفرد، إلا أنها المنطقة الوحيدة في العالم التي يتفوق فيها عدد البلدان الخاضعة للحكم المطلق على البلدان الديمقراطية. وربما لا يستمر الوضع كذلك.
لماذا حققت الديمقراطية مثل هذا التقدم السريع؟ قبل كل شيء الحكومة الممثلة للشعب كانت نادرة عام 1900، ولم يكن أحد يسمع تقريباً بالمعاناة العالمية (بما في ذلك معاناة النساء)، وكانت نيوزلندا استثناءً من ذلك. ولا بد أن تكون الإجابة الأساسية اقتصادية – التحول من مجتمعات يتكون معظم سكانها مع الفلاحين الأميين الذين تترأسهم طبقات ضيقة، أو جماعات من المحاربين والبيروقراطيين والرهبان. ولم يجد احتكاريو القوة والزيف هؤلاء سبباً لتقاسم السلطة مع أولئك الذين يحتقرونهم. وساعد دور المحاربين على جعل المدن الدول استثنائية. وأصبحت جمهورية روما إمبراطورية، وأصبح جنودها محترفين.
غيرت التنمية الاقتصادية هذه الهياكل القديمة: أصبح التعليم الابتدائي أكثر عالمية، وازداد انتشار التعليم العالي، وأصبح الاقتصاد معتمداً على الابتكار الفردي، وانتشرت المعرفة، وازدادت الاتصالات ديناميكية. ويجعل هذا الأمر معظم أنظمة حكم الفرد هشة.

غير أن أقوى سبب للإيمان بمستقبل الديمقراطية هو أنها تستجيب إلى أمر عميق في داخلنا. وكما كتب الاقتصادي ألبرت هيرشمان: إن رغبات بني البشر لها ''صوتها'' في المؤسسات التي تحكم شؤونهم، إضافة إلى أن لهم فرصة ''الخروج'' منها. وقال لنا أرسطو: ''الإنسان بطبيعته حيوان سياسي''. وحين نتحرر من الضغوط اليومية المتعلقة باستمرار الحياة، فإننا كبشر نبحث عن حكومات مسؤولة أمامنا.
وهذه في ما أرى رغبات بشرية يشترك فيها الجميع. والفكرة القائلة إنها غريبة إلى الأبد عن ثقافات بعينها أخذت تبدو غير مقبولة منذ وقت بعيد. وللأسف القوى الغربية غالباً ما قضت على هذا التطلع. وربما يعتقد بعض الغربيين أن هذا هو ما ينبغي للغرب أن يسعى إلى فعله حاليا في مصر. ويبدو أن هذا ليس خطأ من الناحية الأخلاقية فحسب، بل نظرة قاصرة بصورة قاتلة: ربما يكون من الصعب التنبؤ بسلوك الديمقراطيات، لكن الاستبداد والحكم المطلق الذي ندعمه يولد حالة من الكراهية الدائمة.
مع ذلك، وعلى الرغم من قوة التحرك العالمي باتجاه الديمقراطية، وعلى الرغم من السمة العالمية لهذا الطموح، هل يمكن للديمقراطية أن تنشأ وتتطور في مصر؟
التشكك ليس أمرا غير منطقي. فكما يلاحظ زميلي، جديون راتشمان (إذا حالفها الحظ .. مصر يمكن أن تكون شبيهة بتركيا ـ ''الاقتصادية'' 17/2/2011)، استقرار الديمقراطية يسير يداً بيد مع التقدم الاقتصادي. وكلما زاد غنى البلد، ارتفع المستوى التعليمي لأبنائه، ما عدا الحالات التي يأتي فيها الدخل من ريع الموارد. ومرة أخرى، كلما زادت نسبة الفقراء المعدمين، زادت احتمالات النجاح الانتخابي للشعبويين المخربين. وأخيراً، كلما زاد فقر البلد قلت الموارد المتاحة لأي حكومة ديمقراطية لحماية نفسها من أعدائها.
إلى ذلك، الديمقراطية من الناحية العملية هي مجرد حرب أهلية تم ترويضها. ولكي تنجح لا بد أن تلتزم بالقواعد وتجعل الأفكار دعائم لها. وتضم الأفكار حرية التعبير والقبول بشرعية الخصوم.
والواقع أن مصر بلد فقير نسبياً، كما أن نسبة كبيرة من سكانها أميون. ومع ذلك، نصيب الفرد السنوي فيها من الناتج المحلي الإجمالي، باحتساب معادل القوة الشرائية، يكاد يبلغ ضعف نصيب الفرد في الهند، ويزيد بنسبة 50 في المائة على نصيب الفرد في إندونيسيا. ولا يعني هذا الأمر أن الديمقراطية، حسب أي مفهوم، لا يمكن تصور وجودها في مصر. وفوق ذلك توجد في مصر حركة إسلامية جيدة التنظيم. لكن هل يفترض أن يكون ذلك بالضرورة أمراً ضد الديمقراطية؟ لا بد من إخضاع الأمر إلى الاختبار. وعلينا أن نتذكر أن الكاثوليكية كذلك كان يعتقد على نطاق واسع أنها لا تتواءم مع وجود حكومة ديمقراطية ناجحة.
وقبل كل شيء، لنضع في الحسبان الجانب المشرق الناشئ حتى من إقامة ديمقراطية ناجحة بدرجة يمكن احتمالها في أكبر بلد عربي. لقد ارتكب الغرب عدداً لا يحصى من الأخطاء، بل وارتكب أموراً أكثر من الأخطاء في العالم العربي. وهذه فرصة لتقديم مساعدة تحتاج إليها مصر بينما تتوجه نحو مستقبل ديمقراطي. ويمكن للزعماء الغربيين، على الأقل تثبيط أي ميل داخل الجيش لتجديد الدائرة الكئيبة من حكم العسكر، وأن يشجعوا الجيش على حماية الديمقراطية من قهر أي من المشاركين في السياسة الجديدة.
آمل ألا أكون ساذجاً على نحو غير عقلاني. فأنا لا أؤمن بأن انتصار الديمقراطية أمر حتمي في العالم، أو في مصر. وبينما يولد الاقتصاد الحديث فرصاً للانفتاح السياسي، فهو يوفر كذلك مزيداً من أدوات القهر بأكثر مما كان متوافراً تحت أيدي الدولة في السابق.
من المؤكد أن الديمقراطية حققت تقدماً. مع ذلك نجاحها أمر غير مؤكد. وأتساءل في الوقت ذاته ما إذا كان الحزب الشيوعي الصيني يؤمن بأن دولته القديمة ستظل استثناءً. ربما يقبل الناس بحكم الفرد لفترة ما ثمنا للاستقرار والرخاء، لكن بني البشر يريدون أن يتم التعامل معهم بكرامة. آمل ألا تكون هذه هي آخر مرة ينجحون فيها في تحقيق ذلك.
FX-Arabia
|
|
جديد المواضيع |

لوحة التحكم
روابط هامة
|
||||||
| منتدى الاخبار و التحليل الاساسى تعرض فيه الاخبار المتجددة لحظيا و التحليل الاساسى و تحليلات الشركات المختلفة للاسواق, اخبار فوركس,اخبار السوق,بلومبيرج,رويترز,تحليلات فوركس ، تحليل فنى ، اخر اخبار الفوركس ، اخبار الدولار ، اخبار اليورو ، افضل موقع تحليل ، اخبار السوق ، اخبار البورصة ، اخبار الفوركس ، اخبار العملات ، تحليلات فنية يومية ، تحليل يورو دولار |
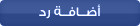 |
|
|
أدوات الموضوع |
|
|
المشاركة رقم: 1 | ||||||||||||||||||||||
|
المنتدى :
منتدى الاخبار و التحليل الاساسى
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
#1
|
|
|
|
|
في عام 508 قبل الميلاد، وبعد الإطاحة بأحد الطغاة أسس الكلسثنيون ديمقراطية في أثينا. وخلال عمرها الذي بلغ 186 عاماً، جلبت هذه الديمقراطية أهم تفتح للروح البشرية، لكن في نطاق جغرافي ضيق. ومع ذلك، إذا كان عمر الديمقراطية 2519 عاماً، فإن مصر أقدم منها بكثير. فقد جرى توحيدها للمرة الأولى قبل خمسة آلاف سنة لتكون بذلك أقدم دولة على كوكبنا الأرضي.
بالتالي، الدولة ككيان أقدم بكثير من الديمقراطية. وجاء اختراعها مصحوبا بسؤال: من الذي يتحكم فيها؟ كانت الإجابة عبر الزمن والمكان إنهم الملوك الآلهة، والملوك الرهبان، والقادة العسكريون، وما إلى ذلك. وربما كانت الحكومة فكرة في اهتمامات أبناء الشعب، لكنها في الغالب لم تكن في أيديهم. كانت أثينا استثناءً عظيماً، على الرغم من أن مفهوم الحكومة المسؤولة أمام الشعب كان موجودا كذلك في روما القديمة وفي دول المدن الإيطالية. ومع ذلك لم يحقق الانتخاب المباشر انتشاراً جغرافياً على نطاق واسع. وحلّ انتخاب البرلمانات في إنجلترا في القرن الثالث عشر تلك المشكلة. وانتشر أنموذج البرلمان المنتخب الذي تعتبر السلطة التنفيذية مسؤولة أمامه في الوقت الراهن في معظم أرجاء العالم. يقدم مشروع بوليتي الرابع في مركز السلام الشامل في جامعة جورج ماسون، تحليلاً للأنظمة السياسية في الفترة 1800 – 2009. ومن بين 162 بلدا غطتها الدراسة تبين أن 92 بلدا كانت محكومة بأنظمة ديمقراطية في 2009، بينما كانت 23 بلدا فقط تخضع لحكم الفرد، مقابل 89 بلدا عام 1977. ومن المؤسف أن 47 بلدا كانت بلدانا هشة تجتمع فيها عناصر الحكم الديمقراطي وحكم الفرد. ورغم ذلك، العالم ديمقراطي في أغلبه، وذلك للمرة الأولى في التاريخ. وما تجدر ملاحظته هو الزيادة الكبيرة في عدد الدول الديمقراطية في التسعينيات، وهو الأمر الذي نشأ عن انهيار إمبراطورية الاتحاد السوفياتي السابق والتحول الذي شهدته أمريكا اللاتينية. ومع ذلك، بقي الشرق الأوسط شاذا عن ذلك. فعلى الرغم من تراجع عدد البلدان الخاضعة لحكم الفرد، إلا أنها المنطقة الوحيدة في العالم التي يتفوق فيها عدد البلدان الخاضعة للحكم المطلق على البلدان الديمقراطية. وربما لا يستمر الوضع كذلك. لماذا حققت الديمقراطية مثل هذا التقدم السريع؟ قبل كل شيء الحكومة الممثلة للشعب كانت نادرة عام 1900، ولم يكن أحد يسمع تقريباً بالمعاناة العالمية (بما في ذلك معاناة النساء)، وكانت نيوزلندا استثناءً من ذلك. ولا بد أن تكون الإجابة الأساسية اقتصادية – التحول من مجتمعات يتكون معظم سكانها مع الفلاحين الأميين الذين تترأسهم طبقات ضيقة، أو جماعات من المحاربين والبيروقراطيين والرهبان. ولم يجد احتكاريو القوة والزيف هؤلاء سبباً لتقاسم السلطة مع أولئك الذين يحتقرونهم. وساعد دور المحاربين على جعل المدن الدول استثنائية. وأصبحت جمهورية روما إمبراطورية، وأصبح جنودها محترفين. غيرت التنمية الاقتصادية هذه الهياكل القديمة: أصبح التعليم الابتدائي أكثر عالمية، وازداد انتشار التعليم العالي، وأصبح الاقتصاد معتمداً على الابتكار الفردي، وانتشرت المعرفة، وازدادت الاتصالات ديناميكية. ويجعل هذا الأمر معظم أنظمة حكم الفرد هشة.  غير أن أقوى سبب للإيمان بمستقبل الديمقراطية هو أنها تستجيب إلى أمر عميق في داخلنا. وكما كتب الاقتصادي ألبرت هيرشمان: إن رغبات بني البشر لها ''صوتها'' في المؤسسات التي تحكم شؤونهم، إضافة إلى أن لهم فرصة ''الخروج'' منها. وقال لنا أرسطو: ''الإنسان بطبيعته حيوان سياسي''. وحين نتحرر من الضغوط اليومية المتعلقة باستمرار الحياة، فإننا كبشر نبحث عن حكومات مسؤولة أمامنا. وهذه في ما أرى رغبات بشرية يشترك فيها الجميع. والفكرة القائلة إنها غريبة إلى الأبد عن ثقافات بعينها أخذت تبدو غير مقبولة منذ وقت بعيد. وللأسف القوى الغربية غالباً ما قضت على هذا التطلع. وربما يعتقد بعض الغربيين أن هذا هو ما ينبغي للغرب أن يسعى إلى فعله حاليا في مصر. ويبدو أن هذا ليس خطأ من الناحية الأخلاقية فحسب، بل نظرة قاصرة بصورة قاتلة: ربما يكون من الصعب التنبؤ بسلوك الديمقراطيات، لكن الاستبداد والحكم المطلق الذي ندعمه يولد حالة من الكراهية الدائمة. مع ذلك، وعلى الرغم من قوة التحرك العالمي باتجاه الديمقراطية، وعلى الرغم من السمة العالمية لهذا الطموح، هل يمكن للديمقراطية أن تنشأ وتتطور في مصر؟ التشكك ليس أمرا غير منطقي. فكما يلاحظ زميلي، جديون راتشمان (إذا حالفها الحظ .. مصر يمكن أن تكون شبيهة بتركيا ـ ''الاقتصادية'' 17/2/2011)، استقرار الديمقراطية يسير يداً بيد مع التقدم الاقتصادي. وكلما زاد غنى البلد، ارتفع المستوى التعليمي لأبنائه، ما عدا الحالات التي يأتي فيها الدخل من ريع الموارد. ومرة أخرى، كلما زادت نسبة الفقراء المعدمين، زادت احتمالات النجاح الانتخابي للشعبويين المخربين. وأخيراً، كلما زاد فقر البلد قلت الموارد المتاحة لأي حكومة ديمقراطية لحماية نفسها من أعدائها. إلى ذلك، الديمقراطية من الناحية العملية هي مجرد حرب أهلية تم ترويضها. ولكي تنجح لا بد أن تلتزم بالقواعد وتجعل الأفكار دعائم لها. وتضم الأفكار حرية التعبير والقبول بشرعية الخصوم. والواقع أن مصر بلد فقير نسبياً، كما أن نسبة كبيرة من سكانها أميون. ومع ذلك، نصيب الفرد السنوي فيها من الناتج المحلي الإجمالي، باحتساب معادل القوة الشرائية، يكاد يبلغ ضعف نصيب الفرد في الهند، ويزيد بنسبة 50 في المائة على نصيب الفرد في إندونيسيا. ولا يعني هذا الأمر أن الديمقراطية، حسب أي مفهوم، لا يمكن تصور وجودها في مصر. وفوق ذلك توجد في مصر حركة إسلامية جيدة التنظيم. لكن هل يفترض أن يكون ذلك بالضرورة أمراً ضد الديمقراطية؟ لا بد من إخضاع الأمر إلى الاختبار. وعلينا أن نتذكر أن الكاثوليكية كذلك كان يعتقد على نطاق واسع أنها لا تتواءم مع وجود حكومة ديمقراطية ناجحة. وقبل كل شيء، لنضع في الحسبان الجانب المشرق الناشئ حتى من إقامة ديمقراطية ناجحة بدرجة يمكن احتمالها في أكبر بلد عربي. لقد ارتكب الغرب عدداً لا يحصى من الأخطاء، بل وارتكب أموراً أكثر من الأخطاء في العالم العربي. وهذه فرصة لتقديم مساعدة تحتاج إليها مصر بينما تتوجه نحو مستقبل ديمقراطي. ويمكن للزعماء الغربيين، على الأقل تثبيط أي ميل داخل الجيش لتجديد الدائرة الكئيبة من حكم العسكر، وأن يشجعوا الجيش على حماية الديمقراطية من قهر أي من المشاركين في السياسة الجديدة. آمل ألا أكون ساذجاً على نحو غير عقلاني. فأنا لا أؤمن بأن انتصار الديمقراطية أمر حتمي في العالم، أو في مصر. وبينما يولد الاقتصاد الحديث فرصاً للانفتاح السياسي، فهو يوفر كذلك مزيداً من أدوات القهر بأكثر مما كان متوافراً تحت أيدي الدولة في السابق. من المؤكد أن الديمقراطية حققت تقدماً. مع ذلك نجاحها أمر غير مؤكد. وأتساءل في الوقت ذاته ما إذا كان الحزب الشيوعي الصيني يؤمن بأن دولته القديمة ستظل استثناءً. ربما يقبل الناس بحكم الفرد لفترة ما ثمنا للاستقرار والرخاء، لكن بني البشر يريدون أن يتم التعامل معهم بكرامة. آمل ألا تكون هذه هي آخر مرة ينجحون فيها في تحقيق ذلك. |
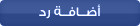 |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| التاريخ, جانب |
|
|
الساعة الآن 06:25 PM











